
حبّات من المسك
خلال استراحة غداء مزدحمة في الاجتماع السنوي للأكاديمية الأمريكية للدين عام 1991، رأيتُ زميلة دراسة سابقة تسرع نحوي. قبل سنوات طويلة، في جامعة شيكاغو، كنتُ قد التحقت مع مارشيا بدورة في معهد الدراسات الشرقية. وبدا عليها الانفعال وهي تقول:
«جورون، يجب أن أحدثك؛ لقد وجدتُ لكِ المندائيين!»
قلتُ بدهشة: «هل تمزحين! أخبريني! هل لديك دقيقة؟»
أجابت بأنها تملك الوقت. وأوضحت مارشيا هيرمانسن، التي كانت حينها أستاذة في جامعة ولاية سان دييغو، أن حوالي أربعين مندائياً عراقياً يعيشون في سان دييغو وضواحيها. وأضافت أنها صارت صديقة لعائلة عمارة، واقترحت أن آتي للقائهم ولإلقاء محاضرة في قسمها في الخريف التالي.
وهكذا فعلت. كانت هذه أول مرة ألتقي فيها بالمندائيين في الولايات المتحدة. فقد جمعت عائلة عمارة، برئاسة لمياء عباس عمارة—الشاعرة المعروفة في العالم العربي والناشطة السياسية والثقافية السابقة—حوالي سبع عائلات مندائية على مأدبة طعام مشتركة. وكلما التفتُّ لأحادث شخصاً جديداً، وجدتُ أطباقاً شهية تظهر فجأة في صحني. كانت أمسية ودّية للغاية، مليئة بالحديث والتعلم والمتعة. لكن وقتي كان قصيراً آنذاك، واتضح أن عليّ العودة لزيارة أطول؛ وقد تحقق ذلك بعد عام، في ديسمبر 1993.
الآن أجلس إلى طاولة الطعام في شقة لمياء، أنسخ أنساب الكهنة من كتب جدها المندائية—وهي وثائق مكتوبة بخط اليد لا تقدر بثمن. الراديو يهمس، التلفاز يعمل، آخرون يتحدثون، وماء المطر يقطر من السقف إلى دلو لأن صاحب البيت لم يتمكن بعد من إصلاح السقف. لمياء على الهاتف، تتحدث بحماس بالعربية مع أحدهم في واشنطن العاصمة حول أمسية شعرية لها هناك.
لمياء، التي تجاوزت الستين، سمراء مهيبة، ذات شخصية ملكة قديمة، تعيش مع أبنائها وأختها في سان دييغو. وهم يصدرون مجلة مندائي، معظمها بالعربية والقليل منها بالإنجليزية، تسعى إلى ربط المندائيين في أنحاء العالم وتعريف القراء بالمندائية. أفراد عائلة عمارة غادروا العراق تدريجياً، ومنذ حرب إيران–العراق (1980–1988) وحرب الخليج عام 1991، ظلوا يتابعون باهتمام أحداث الوطن.
«أنا لست ضد أحد»، تشرح لمياء، «لكنني كنتُ قائدة؛ كنا جيل الثورة». وهي تشير هنا إلى الفترة المضطربة من عام 1963 في العراق. عرفتُ أن لمياء كانت المرأة الوحيدة في الوفد العراقي عام 1959 إلى الصين، حيث التقت بماو تسي تونغ والدالاي لاما حين كان شاباً. لعدة سنوات كانت مندوبة لدى اليونسكو في باريس، وعرفت سياسيين رفيعي المستوى، ودخلت وخرجت من سفارات عديدة. تكتب قصائد حب مشتعلة—وقصائد سياسية أيضاً.
تقول لي في يوم ما بكل بساطة: «لقد قُتلت عام 1963».
فأندهش: «ماذا تقصدين؟» وتشير إلى الأيام الثورية الحماسية في 1963، حين اعتقدت السلطات أنها قبضت على لمياء، لكنهم في الحقيقة عذبوا وقتلوا امرأة شابة أخرى. قضت لمياء السنوات بين 1979–1985 في لبنان خلال الحرب هناك: تختبئ، وتكتب، وأحياناً تعاني من الجوع.
سألتها عن الصابئة المندائيين في العراق، وعن تجربتها وتجربة أختها شفيعة وأبنائها. عبر القرون—إن لم نقل آلاف السنين—عرف المندائيون أن الاضطرابات السياسية غالباً ما تعني المتاعب لهم. فإذا وقع انقلاب يطيح بالنظام القائم، قد يصبحون ضحايا من جديد. وبالطبع، يعاني المندائيون مع بقية العراقيين، إذ أن الاقتصاد خلال الحصار المستمر من بين الأضعف في العالم. المال لا قيمة له تقريباً، لكن عدداً كبيراً من المندائيين في العراق (معظمهم الآن في بغداد) يعملون في تجارة الذهب والألماس. مثل هذه الأصول تمنحهم على الأقل شيئاً ثابتاً وسط اقتصاد منهار. ومع ذلك، كثيرون يعانون الجوع، وحتى أولئك الذين يتعاملون بالمعادن الثمينة غالباً ما يكونون أهدافاً للسرقة والقتل.
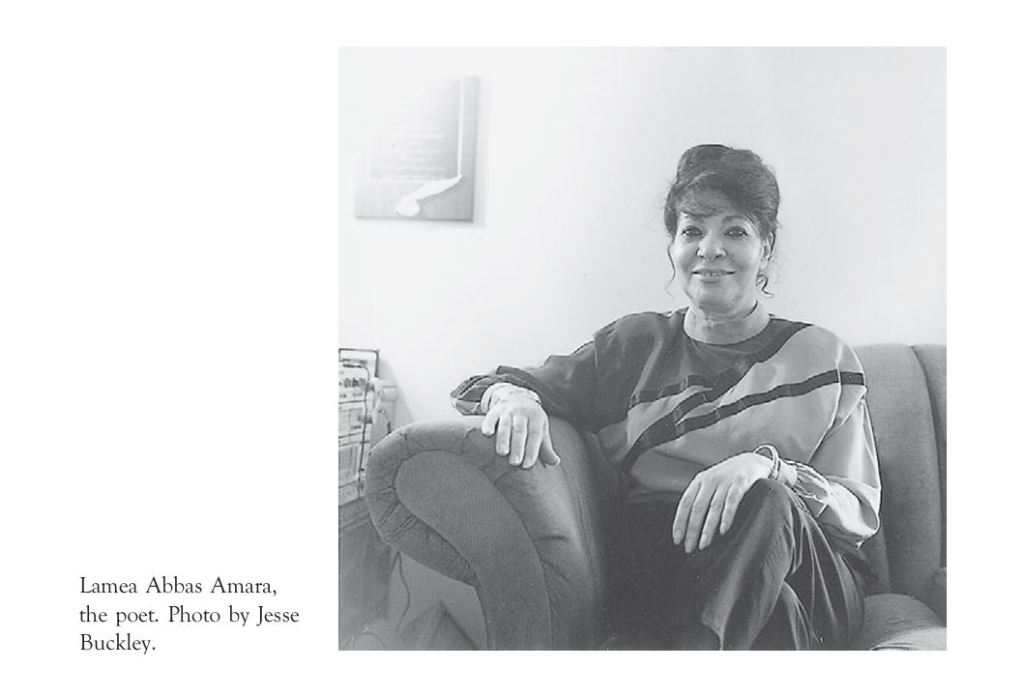
الأصول الدينية، الجيران، والحدود
وردت ثلاث سور في القرآن تنص على أن أدياناً محددة غير الإسلام تملك جزءاً من الحقيقة الإلهية، وبالتالي—بحسب التقاليد الفقهية—لا يجب إجبار أتباعها على اعتناق الإسلام. اليهودية والمسيحية من بين هذه الأديان، لكن جماعة ثالثة تُدعى «الصابئة» كانت موضوع جدل طوال التاريخ الإسلامي. ما المقصود بهذا المصطلح؟ عبر القرون، وُضع المندائيون تحت مظلة «الصابئة»، لكن المسألة لم تُحسم بعد، والعلاقات بين الأديان الأربعة معقدة وتخضع للتغيرات.
في ستينيات القرن الماضي، كان للمياء زوجان يهوديان جيران وأصدقاء في بغداد. أخبرها الزوج، وكان له منصب رفيع في الطائفة اليهودية، أنه بعد حرب الأيام الستة بين إسرائيل ومصر والدول العربية، حين توسعت إسرائيل، جاءته بعض العائلات مدّعية أنها يهودية. قالوا إنهم كانوا يتظاهرون بالإسلام فقط، لكن الآن يمكنهم إظهار هويتهم الحقيقية. فسألته لمياء: «هل قبلتهم كيهود؟»
قال: «بالطبع لا. كانوا معروفين بأنهم مسلمون منذ أجيال عديدة».
أما أنا، هنا في سان دييغو، بين المندائيين؟ مع أنني لوثري متراجع، وبالثقافة مسيحي، أفكر في وضعي. هل يمكن للعائلة أن تسمح لي بالأكل معهم في منزلهم؟ نعم، بالطبع. لمياء وشفيعة تقبلانني في المطبخ، حتى لأطبخ العشاء. شفيعة تتابعني، قلم بيدها، وتدوّن ما أفعله بينما أعدّ السلمون المسلوق بالطريقة النرويجية. يمازحونني بشأن برطمان «بوستم» (لأني لا أشرب القهوة): «قهوة مزيفة للمندائي المزيّف!» وتعلّمني شفيعة كيف آكل بالطريقة المندائية—برشاقة وأناقة. أفشل تماماً، وأُحدث فوضى محاولاً التعامل مع قليل من الأرز والخضار في كف يدي اليمنى بينما أدفع بعضه بإبهامي نحو أطراف سبابتي ووسطاي. ومن هناك، لا يجب أن أدخل أصابعي في فمي، بل أستخدم الإبهام لدفع الطعام إلى فمي دون إسقاطه. أستسلم وألجأ إلى الشوكة.
«مورگا»، وهو يخنة لذيذة من اللحم والخضار، غالباً ما يكون على النار. الأرز والخبز أساس، والدجاج مع مرق قوي وحامض يظهر بانتظام، وأحياناً معكرونة بصلصة لا يعرفها الإيطاليون. حين التقيت العائلة لأول مرة عام 1992، أعطتني لمياء رزم كبيرة من التمر الممزوج بالسمسم. اشترت العائلة التمر من الصحراء وملأت به شاحنة صغيرة مبطنة بقطعة قماش. ربما لا يزال مدخل بيت مارشيا القديم ملطخاً ببقع التمر الذي انزلق من الصندوق حين غسلوا الفاكهة بعد رحلة الصحراء.
تحت الحوض يختبئ دلو كبير فيه زيتون مخلل، جُمِع من الأشجار حول المجمع السكني. الخضار الطازجة، السلطات، والفواكه دائماً موجودة في الشقة. لا أرى خمراً في البيت، ولا أحد يدخن. كتبت لمياء أطروحة عن النظام الغذائي المندائي، وتعتبره مفيداً للغاية. تنسب طول عمر الكهنة إلى طعامهم الصحي. تقول إن كهنة المندائيين يحتفظون بأسنانهم حتى الشيخوخة، ولا يموتون بالسرطان أو الأزمات القلبية، بل «من الرئة»، أي الالتهاب الرئوي—وهو أثر مفهوم للغطس في الماء خلال المواسم الباردة.
عندما نكون ثلاثة فقط—لمياء، شفيعة، وأنا—توزع لمياء أحياناً الحلوى التي تخفيها عن «الأطفال»، أي الأولاد. تختفي الهدايا من الحلويات والبسكويت في خزانة بعيدة عنهم. زكي، الذي ما زال يتعافى من نوبة قلبية أصابته في الأردن، حريص على نظامه الغذائي ويعود دائماً بأكياس من الفواكه والخضار. زيدون يعود من حفل عيد الميلاد في الجامعة محمّلاً بالرمان. «رُمّان!» نأكله بفرح. الأمريكيون في الحفل اعتبروا الفاكهة مجرد زينة، لا طعاماً.
تقول لمياء متنهّدة: «لم أكن أطبخ من قبل، لكن الآن أطبخ طوال الوقت». في العراق، كانت العائلة تعيش حياة مختلفة، مع طباخين وسيارات جميلة وبيوت واسعة. ذهب كل ذلك؛ لا شيء يمكن اعتباره مضموناً. على الأقل، في أمريكا هناك طعام. لكنهم يقلقون بشأن أوضاع الأقارب والأصدقاء في الوطن، نقص الطعام والضروريات، ومعدل التضخم المذهل.
زيدون يشرح لي الطبقات الثلاث: عائلات الكهنة، الناس العاديون، وأولئك الذين يُعتبرون «غرباء». هذا البناء الاجتماعي ما زال يواجه فكرة المساواة الحديثة. ضمن عائلات الكهنة، هناك قواعد خاصة. تخبرني لمياء أنه حين كانت جدتها في فترة الحيض أو بعد إنجاب طفل، كان جدها الكاهن يطبخ طعامه بنفسه ويخبز خبزه بنفسه. عندها أدركت فجأة حكمة تعدد الزوجات.
لم تكن القواعد من نقاط قوة يسوع. فقد جعل الدين المندائي أسهل بتخفيف اللوائح، بحسب الرأي المندائي الشائع. كان في الأصل مندائياً، لكنه أنشأ ديناً خاصاً به. كان قائداً، «مثقفاً»، كما تشرح لمياء، وأراد أن يقوي مكانته. ولكي يصبح كاهناً، طلب المعمودية من يوحنا المعمدان. كان يسوع يعلم تماماً أن نيل الكهنوت على يد نبي يمنحه مزايا معينة. بينما لم يكن يوحنا أول نبي، إلا أنه يحتل موقعاً خاصاً كـ«مجدّد ديني» في المندائية.
لا يوحنا ولا يسوع يهوديان، بل مندائيان. كثير من المندائيين الذين التقيتهم يرغبون في مناقشة هذين الشخصيتين معي. تقول لمياء باعتراض: «كتبتَ في كتابك أن يوحنا كان يهودياً». أعترف بأنني فعلت ذلك، وأشرح أن هذا رأي شائع بين الباحثين. بالطبع قد نكون مخطئين—من يدري! أحاول التوازن برفع يديّ، وأعلّق بأن يسوع، بانفصاله عن المندائية، لم ينجح كثيراً بمقاييسهم. لكن لمياء تؤكد على النقطة الأساسية: أن يسوع أراد السلطة، وعرف أنه لا يستطيع نيلها إلا عبر يوحنا.
أخبرني صديقي المندائي عصام هرمز في السويد منذ سنوات أن يسوع أراد أن يُعمَّد على يد يوحنا لأنه كان يخطط سلفاً لتأسيس دينه الخاص، ليصبح مرتداً عن المندائية. لكنه أراد أولاً أن يضمن خلاص روحه. كان الرجلان ابني عم، وأمهاتهما على وفاق، وكانت مريم (مِرياي) تساعد قريبتها. تقول لمياء مؤكدة: «لو لم تكن مريم مندائية، لما استطاعت أن تساعد خالتها. لم أرَ في حياتي فتاة من دين آخر تدخل بيت جدي لتساعد جدتي. هذا ممنوع. لم يكن مسموحاً حتى أن تدخل البيت». إذاً لا بد أن مريم واليصابات كانتا من نفس الدين.
تنتقد الرواية الإنجيلية المسيحية، إذ تؤكد لمياء أن يوحنا المعمدان، بشخصيته، لا يمكن أن يقول ليسوع: «لستُ مستحقاً أن أحلّ سيور حذائك». هذا كلام سخيف وغير ملائم لشخصيته—فيوحنا ليس رجلاً متواضعاً، بل قوياً صلب الرأي، كما يقولون. بل إنه تحدى سلطة الملك (هيرودس) والحكومة. علاوة على ذلك، لم يكن يوحنا يريد أصلاً أن يُعمِّد يسوع، لأنه كان يعلم أن يسوع سيجعل الدين سهلاً.
في أيامنا هذه، قد يواجه المندائيون مواقف تتطلب إجابات مبتكرة عن سؤال هويتهم. أخبرتُ لمياء بقصة عصام. قبل سنوات، جلست في غرفة معيشته خارج ستوكهولم، وتحدثنا عن السؤال الأزلي: هل المندائيون يهود أم ماذا؟ قال إنه سيخبرني بما حدث معه مؤخراً لأنه يريد أن يعرف إن كنت أظن أن رده كان صحيحاً. بدأ: «أنت تعرف أنني أعمل في بنك كبير، أبرمج أنظمة الكمبيوتر. وقت الغداء نصطف جميعاً لنجلب صواني الطعام. ذات يوم، الرجل خلفي لاحظ صينيتي، وقال: لماذا طعامك دائماً يبدو لذيذاً؟ فأجبته: لا آكل اللحم، خصوصاً لحم الخنزير».
توقف عصام قليلاً، مشمئزاً من فكرة النقانق السويدية ومكوناتها المجهولة. لم أتمالك نفسي وقلت: «إذن، ربما سألك: هل أنت مسلم؟»
هز رأسه: «بالضبط». وأكمل: «أجبته: لا. فنظر إليّ بدهشة، وسأل: ماذا تكون إذن؟ ترددتُ لحظة، ثم قلت: هناك آخرون غير اليهود لا يأكلون لحم الخنزير». يوحي عصام أنه «نصف يهودي» بمعنى ما. بعد ذلك، أحد قادة البنك، وكان يهودياً وسمع بما جرى، صار يحيّي عصام باحترام خاص عندما يراه في الممرات.
في مايو 1994، عرض عليّ ماجد عربي، وهو صائغ شاب في ضاحية إل كاجون بسان دييغو، شريط فيديو لمعموديته في بغداد في يناير من ذلك العام، حين عاد لأول مرة منذ نحو خمسة عشر عاماً. جلسنا في غرفة لمياء—ماجد مع زوجته عبير وابنتهما الصغيرة نورا، ومعنا لمياء وشفيعة وابني جيسي وأنا. أخبرني ماجد أنه غادر العراق وحده عام 1980 لأنه كان يتوقع حرباً قادمة. ذهب أولاً إلى المغرب، ثم إلى أوروبا، وأخيراً إلى نيويورك. وإذ كان قد تعلم حرفة صياغة الذهب من جده، فقد تتلمذ في بروكلين على أيدي صاغة يهود حسيديين مختصين بالذهب والألماس. بقي هناك خمس سنوات، ثم استقل حافلة عبر البلاد إلى سان دييغو.
كان ماجد يحب العيش مع الحاسيديم. قال بابتسامة عريضة:
«نحن متشابهون جداً! نفس الملابس، نفس العادات، نفس روح الدعابة—كل شيء! لقد أدهشني ذلك!»
سألته إن كان الحاسيديم يعرفون أنه مندائي، وهل كانوا يدركون معنى ذلك. أجاب: لا، لم يعرفوا، ولم يهتموا، لكنهم كانوا يعلمون أنه ليس مسلماً. بالنسبة لهم، كان ماجد نوعاً ما مسيحياً. ثم طرح ماجد السؤال الذي يبدو أنه شغله لسنوات: «هل هم مندائيون؟ هل نحن يهود؟»
هززتُ كتفي وأجبتُه كما أفعل غالباً: «حسناً، هذا هو السؤال، أليس كذلك؟ من يدري!»
اليهودية والمسيحية والإسلام تحمل جميعها مكانة خاصة لإبراهيم (أبي الأنبياء). بعض المندائيين أيضاً يرونه أول موحد. وتؤكد لمياء أن المندائية كانت في زمن بعيد ديانة واسعة الانتشار. سقراط كان مندائياً، وكذلك كثير من الفراعنة المصريين، وحتى بعض الأباطرة الرومان. وفي خضم الحماسة التي رافقت اكتشاف مخطوطات البحر الميت، ذهبت لمياء لحضور محاضرة عنها في جامعة ولاية سان دييغو. وبعد المحاضرة، التي ألقاها مدير متحف من إسرائيل، تقدمت نحوه وقالت: «أنا من القوم الذين كتبوا هذه المخطوطات».
فأجابها مباشرة: «أنتِ من العراق؛ أنتِ صابئية».
وحول موضوع الهوية، سألتُها ذات يوم: «هل يمكن في العراق أن تميّز من هو مندائي ومن ليس كذلك؟»
قالت: ليس بالضرورة. في السبعينيات، شرح لي عصام في السويد كيف يمكن للمندائيين أن يكتشفوا ما إذا كان الشخص الآخر من أبناء دينهم. فالمندائي قد يقول شيئاً عادياً، مثل: «هل تريد فنجان قهوة؟» لكن يضيف في نهاية الجملة كلمة «مندائي». فإذا التقط الضيف الكلمة، دلّ ذلك على أنه واحد منهم؛ وإن لم يفعل، فسيفترض فقط أنك أخطأت في الكلام.
تخبرني لمياء أن أبناءها سُجّلوا كمسلمين، حمايةً لهم. تقول: «لم نرد أن يمروا بالتمييز الذي عانيناه نحن». قبل 1958، كان في العراق نظام حصص صارم يحدد وصول الأقليات إلى التعليم العالي. وبما أن المندائيين كانوا نحو 2% فقط من السكان، فقد عانوا من هذه القيود. لكن بعد ثورة 1958، خُففت هذه القوانين، وتمكن كثير من المندائيين من التفوق في التعليم. في الواقع، سمعت منذ سنوات أن المندائيين كانوا يُعتبرون أذكياء بشكل خاص، ونسبة عالية منهم كانوا أطباء ومهندسين ومثقفين وعلماء ومعلمين وغير ذلك.
زكي، ابن لمياء الأكبر، كان واحداً من عدة طيارين مندائيين. أما مازن، ابنها الأوسط، فقد خدم في الجيش ستة عشر عاماً، وأُرسل إلى موقع بالغ الخطورة في حرب إيران–العراق (1980–1988) لأن أحد ضباطه كان يكره لمياء وأراد قتل ابنها. لكن ضابطاً آخر كان على العكس، إذ كان يُعجب بلمياء، فحرص على أن يُعطى مازن عملاً مكتبياً، أكثر أماناً من القتال في الجبهة.
وذات يوم، بينما كنت أجلس منهمكاً في نسخ المخطوطات، دخل زيدون حاملاً سلاحين خطيرين المظهر. فسألته: «مَن أطلقتَ عليهم النار؟ من؟ من؟» فردّ مازحاً، وعيونه تتلألأ: «من؟ من؟»
وعلى الحائط فوق الأريكة علقت جلدتان جافتان لأفاعي جَرسية، وقالت لي لمياء إن زيدون قتل تلك الأفاعي في الجبال. كان زيدون سابقاً بطلاً عراقياً في الرماية، وما زال يتدرب على إصابة الأهداف. ولولا استبعاد العراق من أولمبياد 1988 بسبب الحرب، لكان زيدون قد مثّل بلاده هناك. قبل سنوات، أُرسل إلى يوغوسلافيا للمشاركة في مسابقة دولية للرماية، وتفوق على الجميع.
يميز المندائيون أنفسهم بطرق متعددة. ففي أحد الأيام وصلت شريط كاسيت من بغداد. كانت لمياء وشافية متحمستين، فأدخلتا الشريط في جهاز التسجيل الأصفر الصغير. كان الصوت البطيء الرخيم صوت ابن عمهما، الذي أصبح الآن “شاعر الدولة” في العراق، محمياً مباشرة من الدولة ويعيش، كما توضح لمياء، “في قصر على النهر”. كان يقرأ إحدى أساطير الكنزا عن خلق آدم، باللغة العربية. ألقاها بجدية مع توقفات درامية، وكان الصدى يجعله يبدو وكأنه يتحدث في قاعة ضخمة. جلست الأختان تستمعان، منبهرتين وممتلئتين بالرهبة. قالتا: “جميل.” وبعد فترة أوقفتا الشريط.
أخبرتني لمياء سابقاً أن ترجمة النصوص المندائية إلى العربية محرّمة، لكنها ترى أنه ينبغي القيام بذلك، ويفضل أن يتم من قبل ثلاثة أو أربعة أشخاص معاً. تقول لمياء: “أسرار المندائيين موجودة في اللغة.” ويبدو هذا كأنه دعوة لتركها تبقى أسراراً. ولكن ماذا عن جميع الترجمات إلى اللغات الأوروبية (وأنا نفسي مذنبة بواحدة منها)؟ قالت لمياء: “لا بأس!”، ولم ترغب في مناقشة الموضوع. كان هناك نوع من التردد في هذه المسألة، لكن حرصاً على بقاء الثقافة والدين ونشر المعرفة، يجب القيام بالترجمات، أو هكذا توحي لمياء.
عادت المحادثة إلى موضوع “شاعر الدولة”. أخبرتني لمياء أنها كان بإمكانها أن تكون في ذلك المنصب، لكنها رفضت. قالت: “لا أريد أن أكون مدينة لهم بشيء.” وفهمت قصدها. كما علمت أن هذا الموقع المميز لابن عمها يخلق بعض المشاكل للمندائيين. فمن ناحية، من الجيد أن يكون واحد من أبنائهم في موقع كهذا، فقد يوفّر نوعاً من الحماية لبقية الجماعة. لكن آخرين رأوا أنه قد “اشتُري” من قبل الحكومة.
في عام 1973، بعد عشر سنوات من إعلان “موت” لمياء، استدعيت لمقابلة رئيس العراق أحمد حسن البكر، الذي كان جالساً مع عدة وزراء. قال لها:
«هل تعرفين لماذا أردنا حضورك؟»
فأجابت: «لا أعرف.»
قال: «الناس يحبونك؛ نحن بحاجة إليك.»
فردت لمياء بهدوء: «ليتكم سألتم عني قبل عشر سنوات.»
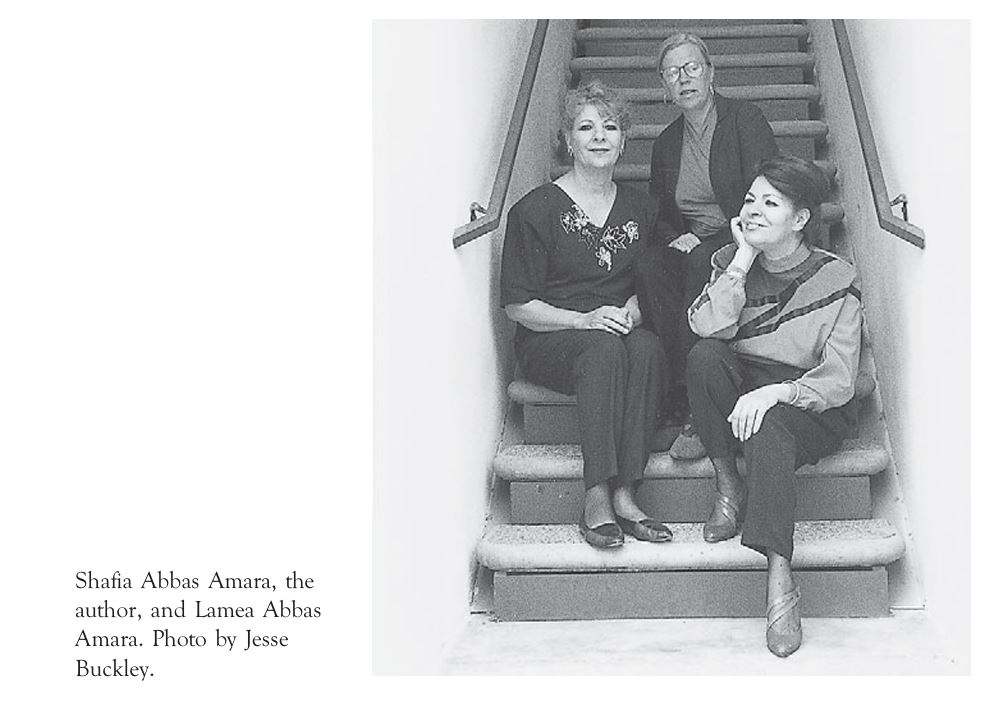
الماضي والحاضر
تتذكر لمياء بيت جدها لأمها، الشيخ جودت في العمارة، قبل الحرب العالمية الثانية. كان الشيخ جودت هو من أعطاها النصوص التي تحتفظ بها الآن في شقتها. رسمت لي مخططاً للبيت: حول فناء مستطيل مركزي تنتظم الديوانية (غرفة جلوس الرجال)، وحظيرة الأبقار والدجاج، والمرحاض الخارجي، والـ تنور (فرن الخبز)، والمطبخ بأرففه العالية التي لا تصل إليها أيدي الأطفال، والجرار الطينية المعلقة لحفظ الماء، وركن مخصص للطعام شتاءً، وغرف النوم. في الخلف، عند أحد الجوانب القصيرة، باب يؤدي إلى الخارج مع درج. كما كان هناك شرفة مسقوفة. وفي الصيف كان الناس يأكلون في الفناء قرب الحديقة، حيث أشجار الفاكهة والنخلة المركزية. وبينما أستمع وأنظر، عاد بي التفكير إلى خريف 1973 وبيت الشيخ عبد الله الخفاجي في الأهواز.
قالت لمياء: «في دهوة ربا (رأس السنة)، ولمدة ست وثلاثين ساعة، تغلق كل عائلة مندائية بيتها ولا تخرج منه.» كانت العائلات تسيّج حديقتها بسياج مؤقت، وترسل أبقارها إلى جيرانها المسلمين. وتبقى الحظيرة فارغة لسبب محدد: إذا حاضت أي امرأة من العائلة خلال تلك الساعات الست والثلاثين، تُعزل هناك. تتذكر لمياء أختها جالسة في الحظيرة، تُطعمها عائلتها.
ولماذا هذا الإغلاق طوال الست والثلاثين ساعة؟ تقول لمياء: هناك تفسيران؛ الأول: أنه إحياء لذكرى كارثة. والثاني: في رأس السنة، ولمدة يوم ونصف، يصعد جميع الـ نَطري (الحُرّاس) إلى عالَم النور. وهكذا تُترك الأرض بلا حماية، ويصبح الخروج خطراً. لذلك لا يجوز لمس أي نبات نامٍ في هذا الوقت، ويقتصر الطعام على ما تم حفظه مسبقاً داخل البيت.
كانت المعلومة الخاصة بالنساء في فترة الحيض جديدة عليّ، ورأيتها كاستراتيجية مفهومة في ظرف صعب. فالدم عادةً يُعتبر نجساً. وبما أنه لا يجوز لأي مندائي الخروج خلال العيد، فلا بد من عزل الفتاة في مكان محدد.
أما النخلة في وسط الحديقة، فلها أهمية خاصة في كل الأوقات، لا في العيد فقط. قالت لمياء: «شَمَش (الشمس) يُظهر الوقت من خلال ظل النخلة. فنقول: أوه، حان وقت حلب البقرة! حان وقت خبز الخبز! من دون شَمَش لا توجد حياة. والبيت الذي لا تدخله الشمس بيت فقير. وعندما تغرب، لا توجد طقوس، لأنه بدون الشمس لا يمكن أداء أي صلاة.» وتضيف أن الكهنة يطلقون لحاهم وشعورهم الطويلة ليشبهوا شمش.
أما ما في الأعلى، من الكواكب والأجرام السماوية، فقد تعلمت مع الوقت أن لا أطرح الكثير من الأسئلة حول الموتى. فهذه مشكلة صعبة للمندائيين في المنفى بالولايات المتحدة، حيث كانوا حينها بلا كهنة، وبالتالي بلا طقوس جنازة صحيحة. في الواقع، كان سؤالي الأول لِلمياء: “كيف يموت المرء في هذا البلد؟” وقبل مجيئي إلى سان دييغو، كان زوجان مسنان قد عادا إلى العراق ليموتا هناك، رغم الظروف. حتى ديسمبر 1993، لم يكن أي مندائي قد توفي في جماعة سان دييغو.
لكن ماذا سيحدث عندما يموت أحدهم؟ قالت لمياء إن لديها رَسْتا (ثوب شعائري)، وإن الرجال سيكونون هَلاليّين (علمانيين يساعدون في تجهيز الموتى) ليتولوا أمر الجنازة. وأشارت إلى مزهرية على الطاولة قائلة: «لديّ آس لصنع كلِيلا [إكليل].» في مدينة نيويورك، كما سمعت، يعتمد المندائيون على الكنيسة الكاثوليكية وعلى استئجار قبور. أما في سان دييغو، فقد رفض الكاهن الكلداني المحلي حتى الآن تزويج المندائيين. وكان هذا مؤلماً لهم، لأنهم يشعرون بالقرب من المسيحية.
في بداية معرفتي بلمياء، كانت ما تزال تحلم ببناء مركز شعائري مندائي في فلوريدا، على نهر، مع مندى (مركز جماعة) وكاهن، حيث تُقام المعموديات والزواجات ومراسم الموتى. لكن حتى الآن لم تُوجد حلول مركزية كهذه. أعربتُ عن قلقي بشأن مصير أرواح المندائيين وأين قد تكون الآن، لكن لمياء فضّلت ألا تتحدث عن ذلك، ليس لأنها غير قلقة، بل ربما لأن المشكلة أكبر من أن تُحتمل.
وفي حديث مرتبط، بَسَطت لمياء رؤيتها عن الروح والحياة بعد الموت. قالت: «الروح لا تفنى أبداً.» ثم وصفت الفردوس، عالم النور، بأنه مكان سلام، مليء بالطعام، والموسيقى، والنسيم العليل، حيث لا حاجة للكلام، لأن الجميع يعرف ما يريده الآخرون. وأضافت: «هناك شخص يشبهني ينتظرني هناك. إنها تنتظر، سعيدة جداً لتحتضنني حين أصل—لدي قصيدة عن ذلك.»
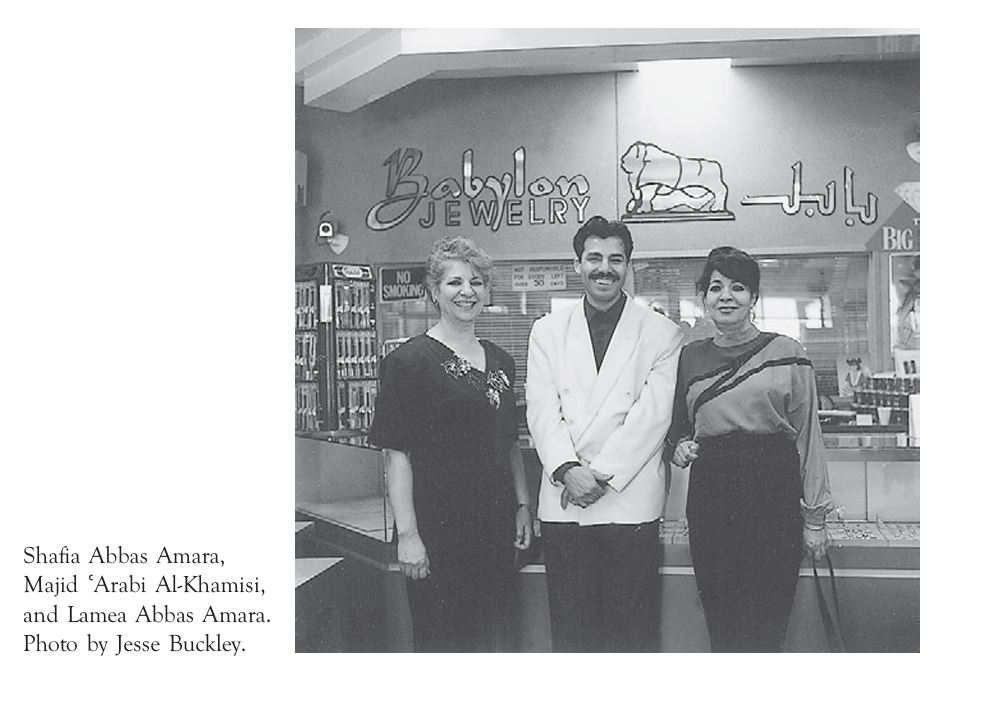
هنا، على الأرض، نحن نعيش بشكل مؤقت فقط، كما في سجن؛ إنه مكان معاناة. لكننا ذاهبون إلى مكان جميل. كل شيء وكل شخص له نظير سماوي؛ حتى الأشجار.»
فقاطعتها قائلاً: «الأشجار؟ وماذا عن هذا الكرسي؟»
قالت: «نعم.»
قلت بدهشة: «حقاً؟»
قالت: «نعم، لأنك تحمله في خيالك. ستأخذه معك.» ثم تابعت: «عندما تموت، تعود روحك إلى أصلها. الروح يمنحها الله للطفل. وفي نهاية الحياة، يصبح البدء هو النهاية—كما في قدر ماء كبير. فالماء دائم الحركة؛ إنها دورة لا تنتهي.»
أسماء الله المختلفة—إيل، أدوناي، وغيرها—ليست سوى أسماء، أما الله فهو واحد، تشرح لمياء. فسألتها: «وهل هناك نساء أيضاً؟»
فأجابت: «نعم، سيمات هييّا! إنها تحمي الأطفال وأمهاتهم، مثل عشتار.» وأثناء حديثنا عن عشتار، تخبرني لمياء أن بوابة بابل كانت في الأصل بوابة عشتار، وقبلها كانت بوابة إيل. والبوابة ما تزال موجودة، وكذلك معابد حمورابي ونبوخذ نصر، وقد تم ترميمها.
منذ سنوات، كما قيل لي، أعلنَت الحكومة العراقية عن جائزة لأفضل إجابة عن سؤال: كيف كان يتم سقي حدائق بابل المعلّقة الشهيرة؟ قالت لمياء: «الجميع بدأوا يفكرون. طبعاً في تلك الأيام في بابل لم تكن هناك آلات.» بدأنا نتأمل في المشكلة الهندسية، فاقترحتُ صفاً من ألف شخص يحملون دلاء ماء. فقالت لمياء: «ربما»، دون اقتناع كبير. ثم أوضحت أنه لا تحتاج إلى الماء إلا في أوقات معينة من السنة. وقد اختارت الحكومة 200 إجابة من بين الأفضل، لكني نسيت أن أسأل إن كانوا قد حصلوا جميعاً على جوائز.
وأنا جالس على طاولة الطعام لثمانية أيام أنسخ أنساب الكهنة من كتب لمياء، كنت أقوم بنوع خاص بي من الغوص في ذلك النبع المندائي العميق: قوائم الأسماء. أملأ صفحة بعد صفحة، أتمتم بالأسماء وأقارن الأنساب، وأحياناً أتعرف على اسم وسلسلة نسبه فأهتف: «آها! أعرفه!» كان أفراد العائلة يروحون ويجيئون، يلقون نظرة على عملي. وكتبت لمياء تقريراً لمجلتها عمّا أقوم به. وبعد أن شرحت عملي لزيدون، قال بهدوء: «ليساعدك مندا د-هييّا!» سألت شافية: ماذا سيفكر مئات الكهنة من الأجيال الماضية لو عرفوا بما أقوم به؟ فقالت إنها كانت تفكر في الأمر، وقد قررت أنهم سيكونون مسرورين وسيباركونني.
كانت أوعية الزيتون وأكواب بوستوم (مشروب ساخن بديل عن القهوة) تقطع العمل، وأحاول إبقاء مسافة آمنة بين الطعام أو الشراب والكتب المقدسة. يمر الضيوف ويلقون نظرة على النص، ويسألون: «هل تقرأ هذا؟» وأشعر بوخزة خفيفة من التجديف عند لمس الكتب، وأنا أخرجها من أكياس القماش القطنية وأعيد لفّها فيها، وأفرز حبات المسك الموضوعة في الأكياس لتبقى الكتب محاطة بـ روها د-هييّا، أي نسمة الحياة.
ألاحظ أن ماجد، في تلك الأمسية حين نشاهد شريط فيديو معموديته، كان يستنشق بعاطفة عبير أحد كتب الكنزا ويقبّله حين يمر بين يديه. قال إنه يجب أن يكون طاهراً ليمسك به. عندها فكرت في نفسي، وفي زوج ابنتي جيسي، الذي كان معي في تلك المناسبة ليلتقي بالعائلة ويلتقط صوراً فوتوغرافية. كان جيسي قد تخرج للتو من قسم الأنثروبولوجيا في جامعة كاليفورنيا–بيركلي، وكان يُسمح له برؤية الكتب والتعامل معها. وقد أدهشه صدام الثقافات: بينما كانت المغنية سيندي لوبر ترقص وتغني على شاشة التلفاز، كان هو يتصفح بعناية نصوصاً مقدسة ذات مهابة عظيمة.
الكهنة والصاغة
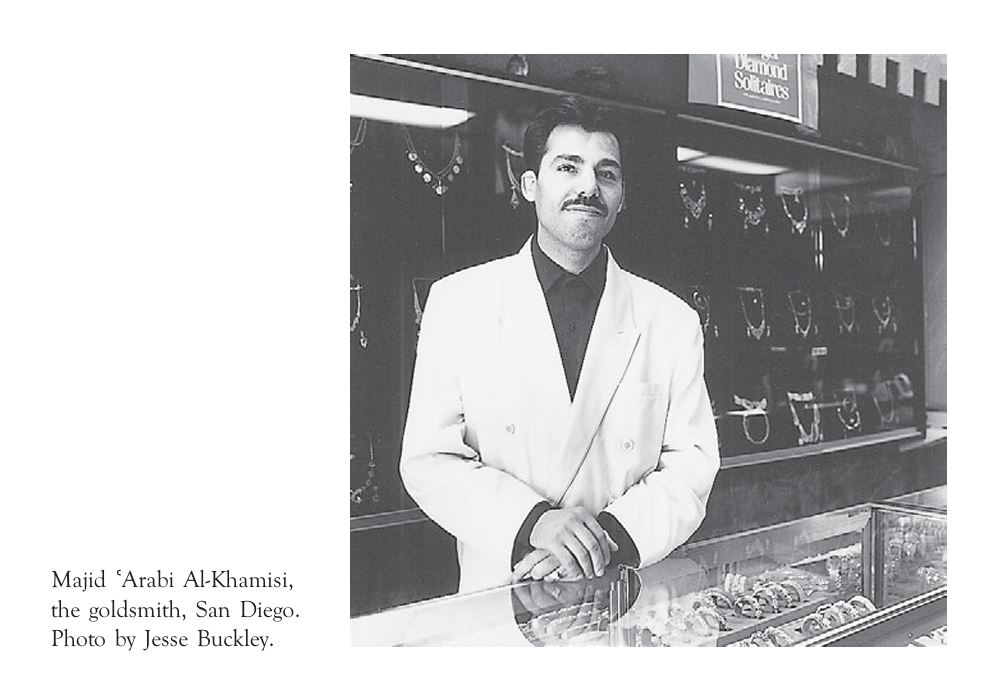
يُعَدّ الشيخ محيي، سلف لمياء، قديساً عند المسلمين والمندائيين على حد سواء. فقد صنع المعجزات حتى بعد وفاته. يقال إنه أوقف فيضاناً في نهر العقيقة قرب الناصرية. ارتفع الفيضان، وراح الناس يكدّسون الأكياس الرملية، واستنجد المسلمون بأوليائهم دون جدوى. ثم نادوا باسم الشيخ محيي، فتوقف الفيضان فوراً. وبامتنان، بنى المسلمون مقاماً له.
بعد وفاة الشيخ محيي مباشرة، حاولت أخته المفجوعة أن تأخذ تراباً من قبره. فألقت بنفسها على القبر، لكنها التصقت به ولم يستطع أحد أن يبعدها. وعندما تمكنت أخيراً من الانفكاك، اعتذرت للشيخ محيي عن مبالغتها في إظهار الحزن ووعدت أن تحزن على الموتى بطريقة أكثر احتراماً. تؤكد لمياء أن هناك شهوداً موثوقين لهذه الحادثة.
ثم أسمع قصة عن خلاف عائلي قديم على نسب الكهنوت. تبدأ لمياء قائلة:
عندما توفي الـ«گنزبرا» (الكاهن الأكبر)، أراد عدة رجال من العائلة أن يحلوا محله. فقال أحد الفروع: «إنه دورنا». فتولى أحدهم المنصب. لكن هذا الأمر أثار نزاعاً. وبما أنه محرم على المندائي قتل إنسان، فقد دفع الطرف المتضرر مالاً لغريب كي يقتل الكاهن الجديد. لكن الغريب لم يكن يعرفه، بل فقط أن بيته على النهر. فانتظره هناك. وخرج الشيخ مع أحد أقاربه، وقبل أن يقفز إلى قارب صغير، نادته زوجته باسمه: «لقد نسيت شيئاً!» فعرفه الغريب، وأطلق عليه النار ببندقية كبيرة.
تتوقف لمياء وتنظر إليّ بتمعّن: «الآن تعلم أن الرجل الذي قُتل هو گنزبرا. ويُحرّم أن يموت الكاهن ودمه عليه. لذا يغيّرون ملابسه البيضاء، الرستا، سبع مرات وهو لا يزال ينزف. فالرستا يجب أن تبقى بيضاء وطاهرة. ومع الثامنة، لم يبق دم، فمات.»
وتواصل: «أقسم أخو الميت أن يقتل أحد أفراد ذلك الفرع من العائلة. لبس صوفاً خشناً بدل القطن، وأقسم أن لا يغيّره حتى يأخذ بثأره. اشتكى الناس إلى شيخ المسلمين المحلي، فأُودع الأخ السجن. قيود ثقيلة في يديه ورجليه، كرة حديد ضخمة، وغرفة بلا نافذة.
وبما أنه كاهن، سُمح له أن يتلقى طعاماً من أهله. فجاءه ابن عمه، فأمره أن يخبئ سكيناً صغيرة داخل الخبز. حصل عليها، وحفر طوال الليل في الجدار السميك متراً. ثم وضع عباءته الصوفية على رأسه مع السلسلة الحديدية. وكان شتاءً قارصاً. سبح عبر الفرات حتى وصل إلى شيخ قبيلة مسلمة على الضفة الأخرى وقال له: «داخلَك! أنا في حمايتك!»
نظر إليه الشيخ، ورأى الكرة الحديدية، وعباءته غير مبتلة، والبرد القارس. فقال: «الرجل الذي يعبر الفرات دون أن تبتل عباءته وهو يحمل هذه السلسلة الثقيلة ويأتي إليّ—لن يمسه أحد! أرسل رجالي ليمنعوا قتله. ماذا تريد؟» فأجاب: «أريد أن أعود إلى بيتي.»
توضح لمياء أنه كان مسجوناً في بلدة أخرى. «ففكوا قيوده، وكان جائعاً، فأرسلوا رجالاً معه وحصاناً ليعود إلى بيته.»
ثم رأى حلماً: جاءه أخوه المقتول وقال له: «يا أخي! عد إلى حياتك الطبيعية. لا تثأر لمقتلي. فالشيخ (من الطرف الآخر) لن يرزق بأبناء يمكن أن يصبحوا كهنة.» تتوقف لمياء لحظة وتضيف: «وحتى الآن، هذا صحيح. وُلد بعضهم عُمياناً أو معاقين، ولم يستطع أحد أن يصبح شيخاً.» ثم تتابع: «قال له أخوه الميت: سأفعلها عنك.» وأخيراً تضيف: «عندما قُتل الشيخ، قصّت النساء شعورهن الطويلة المتموجة، وربطوها بخيوط طويلة في بيوتهن، كما فعلت عشتار عندما مات تموز وطلبت من النساء قصّ شعورهن.»
غالباً ما يكون الخطر على المندائيين من الغرباء لا من الداخل. فعندما حاولت الليدي دراور الاتصال بجد لمياء، الشيخ جودت، وعائلته، حذّرهم قائلاً: «لا تكشفوا أسراركم للغريب!» أما دراور، وبشيء من السذاجة، فكانت ترى أن على المندائيين أن يطالبوا بأرض خاصة بهم مثل الآشوريين الذين ثاروا في شمال العراق في الثلاثينيات طلباً لدولة. تقول لمياء: «كان هذا خطيراً جداً.»
في القرن السابع عشر، أجبر الجيش البرتغالي رجال المندائيين على الخدمة العسكرية في الحروب الاستعمارية. وعندما دخلوا محال الصياغة المندائية، سألوهم: «من أنتم؟» فأجابوا بأنهم أتباع يوحنا المعمدان. فأُرسل عدد كبير منهم إلى سريلانكا (سيلان حينها). والآن، نحن—لمياء وشافية وأنا—نتساءل: ماذا حل بالمندائيين هناك؟ لم يسمع أحد عنهم منذ ذلك الوقت. هل اندمجوا مع السكان السنهاليين؟ هل اعتنقوا ديانات أخرى؟ أم بقي منهم من عاش منعزلاً؟
في إحدى الأمسيات، سأل صديق فلسطيني مسيحي للعائلة، رجل مسن دعانا لعشاء فاخر: «ولماذا أصبحت مندائياً؟» قالها بفضول صادق. فأجبته: «أنا لست مندائياً. لا يمكن التحول، فهذا غير مسموح.» فاستغرب الرجل. لم تشرح لمياء، بل اكتفت بابتسامة. وعندما هممنا بالأكل، رسمت لمياء إشارة الصليب. تأملت ذلك، وسألتها في اليوم التالي. قالت: «أفعل ذلك كثيراً. لا يضر. مثلاً، في الطائرة، أقوم به.»
في ليلة أخرى ذهبنا إلى بيت ماجد لنشاهد فيديو لمطرب بغدادي مشهور جاء إلى سان دييغو لإحياء حفل للجالية العربية. كان ماجد أحد الرعاة. جلست لمياء وشافية مأسورتين بالشاشة، بينما راقب زكي وزيدون بملامح متحفظة ممزوجة بالاهتمام. كان المطرب، ببدلته الصفراء، يبدو واثقاً من شعبيته، نصف خجول نصف متحدٍّ. وأثناء غنائه، يصعد رجال من الجمهور ليغدقوا عليه المال، فيقف تحت مطر من الأوراق الخضراء. في الطريق إلى البيت، دار نقاش حاد حول مزايا المغني. سألت عن الموسيقى والرقص، وهما منبوذان تقليدياً في المندائية. أجابوا: «لا، المندائيون ليسوا أهل غناء أو رقص.»
ومع ذلك، فإنهم يرقصون. لدى ماجد فيديو آخر، لحفل أُقيم عند عودته إلى بغداد بعد خمسة عشر عاماً. النساء كنّ وحدهن، يتحدثن ويبتسمن. والرجال يرقصون، وماجد في الوسط يبدو سعيداً. الجو احتفالي، وهو يُستقبل كابن عائد بعد طول غياب. قال لي: «هؤلاء أقاربي.» فسألته بدهشة: «جميعهم؟» قال مبتسماً: «أوه، هؤلاء فقط نحو مئتين!» أما عن الرقص، فتشرح لمياء: «يجب أن يتصرفوا مثل العرب في الحفلات. وإلا قد يُنظر إليهم على أنهم نادٍ سياسي—وهذا غير جيد.»
الكاهنات والذهب
لمياء، وشافية، وأنا شكّلنا نادينا الخاص، وأسمته لمياء “الفتيات الذهبيات” على غرار المسلسل التلفزيوني. أثناء استراحة خفيفة ونحن نزور صاغة مندائيين في ضواحي سان دييغو، جلسنا في متجر يبيع الزبادي المجمّد. قارنا أعمارنا؛ كنتُ أنا الأصغر. طمأنتني لمياء قائلة: «عندما تبلغين الخمسين، ستصبحين طاهرة؛ لن تعودي تمرّين بالدورة الشهرية.»
فكرتُ بالطهارة، وبالطعام، وبالزواج. الشباب الذين نلتقيهم، الصاغة، جميعهم متزوجون من نساء مندائيات. عندما قابلتُ لمياء وعائلتها لأول مرة، في عشاء جماعي، جاءت أمهات شابات جميلات بشكل لافت ومعهن أطفالهن. ترتدي الطفلات أساور ذهبية صغيرة وأقراطاً. فالذهب هو معدن الروح، كما يقول الملك السامي. لا يبدو أن خطر انقراض الحرفيين وشيك بالنسبة لجيل الشباب، رغم أن كثيرين يعتقدون أن الهوية المندائية ستذوب قريباً، خصوصاً عبر المصاهرة.
الصاغة الشباب بدوا مزدهرين. أحدهم، زاهر غانم، كان يعمل مشتري مجوهرات وأحجار كريمة لمتجر “مارشال فيلدز” في شيكاغو قبل أن يفتتح عمله الخاص خارج سان دييغو. في أول أمسية لي هناك، أهدتني زوجته زوجاً جميلاً من الأقراط الفضية. وفي متجر خالد الجديد، انتظرنا قرب الجدار المغطى بالمرايا حتى أنهى أحد النساطرة الأثرياء مبيعات عيد الميلاد الخاصة به. كان غير مستعجل، يحتسي القهوة من كوب «ستايروفوم». وبعد أن مرر حزمة من المال الأخضر عبر المنضدة، خرج مع كيس بلاستيكي مليء بالذهب. فالشرقيون يميلون إلى دعم بعضهم بعضاً في التجارة. وأثناء انتظارنا، تأملتُ معروضات البضائع الدينية: قلائد ذهبية منحنية متقنة باسم «الله» للمسلمين، نجوم داود لليهود، صلبان وتماثيل مريم العذراء للمسيحيين، وأسود بابل وبوابات عشتار للجميع.
لكن في المتجر الصغير لرجل أكبر سناً، أمجد باهور، الأستاذ الحقيقي والحِرفي، شعرتُ أنني نُقلتُ إلى إيران. هنا وجدتُ نوع المجوهرات النادرة—يدوية الصنع، بتصاميم باهرة. علمتُ لاحقاً أنه من القلة في أمريكا الذين يعرفون الوصفة القديمة السرية للون الأسود المندائي المميز في الفضة، المينا، المستخدمة في زخرفة مناظر صغيرة: مشاهد الأهوار بالقوارب والنخيل، أو نقوش هندسية تجريدية. أعجبتُ بخنجر ذهبي صغير جداً في غمده، أخرجتُ النصل المصغر، لم يتجاوز طوله ظفري. وتذكرتُ قطعة مجوهرات رأيتها في متجر مندائي بالأهواز عام 1973: خاتم ذهبي يحمل رأس ثور صغير كامل، بقرونه ومنخريه وعينيه. أهداني السيد باهور خرزة زرقاء من الفيانس وصلت حديثاً من بغداد. ارتديتها في سلسلة ذهبية، بالتناوب مع دربشا (راية مندائية) أهداها لي ماجد. ولاحقاً، عندما التقيت السيد ناصر صبّي في نيويورك، أعطاني دربشا فضية لأضعها في سلسلة مفاتيحي. راحت التعاويذ الحامية تتكدس عندي.
في أكتوبر 1994، جاءت لمياء لتلقي أمسية شعرية في المركز الإسلامي في شارون، ماساتشوستس. ارتدينا أجمل ملابسنا وذهبنا، أنا وزوجي، وكنا من بين القلائل الغربيين الحاضرين. بدت لمياء ملكية الطلة، بفستان شيفون أسود مطرّز بالذهب، وأبصارنا شدتها قلادتها الذهبية المتلألئة المرصّعة بحجر ياقوت كبير يتوسط عنقها. جلسنا إلى موائد مستديرة، وتناولنا طعاماً شرقياً رائعاً، واستمعنا إلى موسيقى حيّة—طبلة وعود وقانون—وتبادلنا الأحاديث.
تم تصوير عرض لمياء. جلست على طاولة على المسرح مع شابة تقرأ بعض أشعارها مترجمة إلى الإنجليزية، فيما ألقت قصائد أخرى بالعربية فقط. بتركيز عميق على الجمهور وانحناءة نحو الميكروفون، سحرت الحضور، فصفقوا وضحكوا وتنهدوا، بل وبعضهم شهق كأنه طُعن—كلٌّ بحسب مضمون القصائد. امرأة عراقية على مائدتنا غلبتها مشاعرها فخرجت لتبكي. وفي الاستراحة، كان رجل يبدو كأستاذ متقاعد من هارفارد يدور في القاعة وهو يصفق بأصابعه بمرح. وفي الختام، وقفت امرأة مسنّة وشكرت لمياء قائلة إن الأمسية أعادت إليها ذكريات طفولتها مع المهاجرين العرب الأوائل إلى الولايات المتحدة، الذين كانوا يقضون أمسياتهم في بيوت بعضهم يلقون الشعر العربي. تساءلت بأسى: «لماذا لم نعد نفعل ذلك؟»
ظل الجو مشبعاً بعبق الشعر، حتى بدا الناس مترددين في مواجهة ليل الخارج.
The Mandaeans:
Ancient Texts and
Modern People
JORUNN JACOBSEN BUCKLEY
تشرفنا بزيارتكم ونتمنى دائما أن ننول رضاكم.